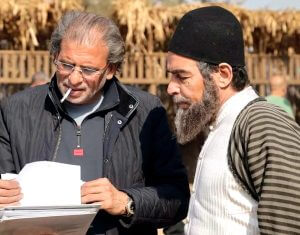
بقلم المخرج المسرحي الكبير: عصام السيد
لا يوجد إجماع على أى عمل فنى في العالم، إذا أعجب الجمهور لم يعجب النقاد، وإذا فاز بإعجاب الاثنين لابد و أن تجد من لا يقبله، ويراه سيئا أو على الأقل لا يستحق كل الإشادة التي حصل عليها، فلكل قاعدة شواذ، وفي مجتمعاتنا الشرقية يتمسك كل شخص برأيه و يعتبر ماعداه خطأ – إن لم يعتبره كُفرٌ والعياذ بالله – فهكذا خُلقنا: أكثر الكائنات جدلا، أما في المجتمعات الغربية المتحضرة فهناك اعتراف بالاختلاف، وقبول به، ولا يصادرون حق غيرهم فيه، فلا يصدرون أحكاما مطلقة، ولا يتهمون من أعجبوا بعمل ما بأنهم لا يفهمون!، ومن هنا جاء التعبير الإنجليزى الشهير: (isn’t my Cub of tea it)، وترجمته الاصطلاحية (أن هذا الشيئ لا يوافق ذوقى)، وهو تعبير يقال في حال لم يعجبك شيئ أجمع الناس عليه.
و لكن الملاحظ أن الأعمال التي تحوز على إعجاب الغالبية العظمى هى تلك التي تلتزم ببعض القواعد الفنية التي جرى الاستقرار عليها منذ الأزل، أولى تلك القواعد أن المخرج – أو صناع العمل بقيادته – يعقدون فى بدايته (اتفاقا ضمنيا) مع المشاهد، وهو اتفاق غير مكتوب وغير معلن ويتم تمريره بطريقة غير مباشرة من خلال بدايات العمل، هذا الاتفاق الضمنى هو ما يضمن للعمل سياقا متصلا واتساقا بين أجزائه، ويخلق قانونا للعمل يكمن بداخله، فلو أهّلت المشاهد من خلال الأحداث أن هذا العمل كوميدى فلابد أن تحافظ على تلك الروح طوال الوقت، حتى و لو كانت كوميديا سوداء، أو العكس في حال التراجيديا.

و لابد أن يلتزم صناع العمل طوال الوقت بهذا الاتفاق الذى وضعوه، ولا يجوز كسره أو الخروج عليه إلا لو كان هذا مقصودا أو مبررا، وإلا فإن المشاهد سيرى تناقضا في العمل يصرفه عن متابعة مشاهدته أو يتصيد له الأخطاء، هل تتخيل مثلا أن ترى (أوديب) – بعد أن عرف أنه قتل أباه وتزوج أمه وتسبب في الطاعون الذى أصاب طيبة – يلقى بعضا من النكات قبل ان يفقأ عينيه؟، ذلك هو أبسط مثال للاتفاق الضمنى، ولكنه في الحقيقة له صور متعددة، وحتى لا نتوه في التعريفات دعونا نضع مثالا يوضح المقصود من أحد مسلسلات هذا العام والتي لم تلتزم باتفاقها الضمنى الذى طرحته على المشاهد، وكان ذلك أحد الأسباب في توجيه سهام النقد اليها:
في مسلسل (سره الباتع) قدم لنا المخرج خالد يوسف في الحلقات الأولى مشاهد توحى بوجود قوى أجنبية تسعى خلف خطابات العالم الفرنسي (الذى قام بدوره الفنان حسين فهمى) و تتآمر للحصول عليها، وكانت كل هذه المشاهد باللغة الفرنسية تصاحبها ترجمة عربية، وبذا قد وضع اتفاقا ضمنيا مع المشاهد أن الأجانب يتحدثون لغة مغايرة، ولكنه قدم فيما بعد (نابليون بونابرت) وجنوده يتحدثون العامية المصرية، بل هي عامية سوقية، حيث يقول أحد القادة الفرنسيين (وحياة أمك)، وهنا نقض المخرج اتفاقه الضمنى، فنحن أمام نفس الجنسية يتحدث بعضها بالفرنسية وبعضها بالعامية المصرية المتدنية دون سبب واضح أو تبرير مقبول!، وهكذا دفع المشاهد أن يتساءل عن سبب الاختلاف في اللغة بين الاثنين، وإذا لم يتساءل المشاهد فإن هذا الاختلاف سيجعله يحس بعدم الاتساق، وهو شعور يدفعه تلقائيا للانصراف أو تصيد الأخطاء، كل ذلك يتم بشكل لا شعورى عند الغالبية العظمى.
كان الطريق للحفاظ على ذلك الاتفاق أن يتحدث أعضاء الحملة كلهم باللغة الفرنسية اتساقا مع ما قدمه المخرج في مشاهد الفرنسيين المعاصرين، والسؤال الآن: هل كان في استطاعة المخرج توفير هذا العدد من الممثلين المتحدثين بالفرنسية؟، أعتقد أنه كان صعبا ولذا كان الحل البديل هو أن يتكلم كل الأجانب باللغة العربية الفصحى، سواء كانوا من الفرنسيين المعاصرين أو من أعضاء الحملة توحيدا لنوع اللغة بينهم، وتحقيقا للاختلاف عن باقى المصريين الذين يتحدثون العامية.

أمر آخر على مستوى اللغة لم يحقق للمشاهد اندماجا في مشاهدة العمل وأعتقد أنه وقف حائلا أو على الأقل لم يحقق المصداقية المطلوبة في مثل هذه الأعمال وهو استخدام العامية المصرية، فقد كان من الواجب أن تختلف في زمن الحملة عن الزمن الحالي، ولدى المخرج (وهو الكاتب أيضا) كتاب تاريخ الجبرتى – الذى عاصر الحملة الفرنسية و دوّن وقائعها – والذى يعتبر مرجعا هاما للتعبيرات العامية في ذلك الزمن، فالمصريين كانوا ينطقون اسم بونابرت (بونابرتة) ولم يعرفوا لفظ (جنرال) وإنما قائد الجند كان يسمى (سارى عسكر)، وكيف لى أن أصدق (حامد أو صافية) وهم يتحدثون بنفس التعبيرات التي نقولها اليوم، حتى أن (صافية تقول في أحد المشاهد: (عاوزة اقعد معاه على انفراد)، وكان الأبسط والأصدق أن تقول (عاوزه اقعد معاه لوحدى، أو وحدينا).
اتفاقا ضمنيا آخر وضعه المخرج مع المشاهد من خلال أنه يتحدث عن فترة تاريخية محددة وبشكل واقعى، وتظهر في العمل شخصيات حقيقية مرت في التاريخ (مثل بونابرت) فكان الواجب الالتزام بالصورة الذهنية الشهيرة لتلك الشخصيات من حيث السمات الجسدية إلى جانب الالتزام بكل مفردات ذلك العصر من ملابس وإكسسوار وأثاث، والحقيقة أن مصممة الملابس بذلت جهدا كبيرا في مطابقة الواقع التاريخى (باستثناء بعض الأخطاء غير المقصودة)، ولكن تلك المطابقة – وهى من ضمن الاتفاق الضمنى مع المتفرج – تم كسرها في مواضع كثيرة، فعلى سبيل المثال: فات المخرج أن ذلك الزمن لم يعرف المناضد وأن الأكل – في المجتمع المصرى – كان على الطبلية في الريف وفي معظم الطبقة الوسطى، أما الطبقات العليا فكانت تستعمل صينية الطعام النحاسية والتي تشبه الطبلية في الارتفاع وتختلف في الاتساع، وأنه من المعروف أن الرجال يأكلون وحدهم دون مشاركة النساء، وربما استمر هذا التقليد في الطبقات الوسطى حتى ثورة 1919، وهذا أمر معروف ومذكور في أعمال أدبية كثيرة مثل ثلاثية نجيب محفوظ.
كل هذه التشوهات في الاتفاق الضمنى استفزت المشاهد ودفعته إلى البحث عن الأخطاء حتى الدقيقة منها أو غير الملحوظة، كما رأينا في حديث البعض عن عربات الركوب التي كانت تجرها الأحصنة (كارته) بأنها لم تكن منتشرة إلى درجة استعمالها في الريف، وحتى لو استعملت فلن يحيط عجلاتها إطار من (الكاوتش)!، فأى متفرج مدقق هذا الذى يلاحظ (الكاوتش)؟
تلك مجرد أمثلة بسيطة لهذا الاتفاق الضمنى الذى أراه هاما ولازما لنجاح العمل، و اعتقد أن الحفاظ عليه سيجنب صناع العمل كثيرا من النقد، فله (سره الباتع) في اقناع المشاهدين.


