يحيي العلمي يكشف سر دموع صلاح السعدني
* تأثر بالسينما العالمية الجديدة فوجد ضالته في أدب جمال الغيطاني
* ليخرج صلاح السعدني من حالة البكاء والانهيار اصطحبه هو والغيطاني لنزهة على النيل
أعجب بقصة (الزعبلاوي) لنجيب محفوظ وكان يريد معرفة أجابات لاسئلته وعندما قابله أخفى الأسئلة!
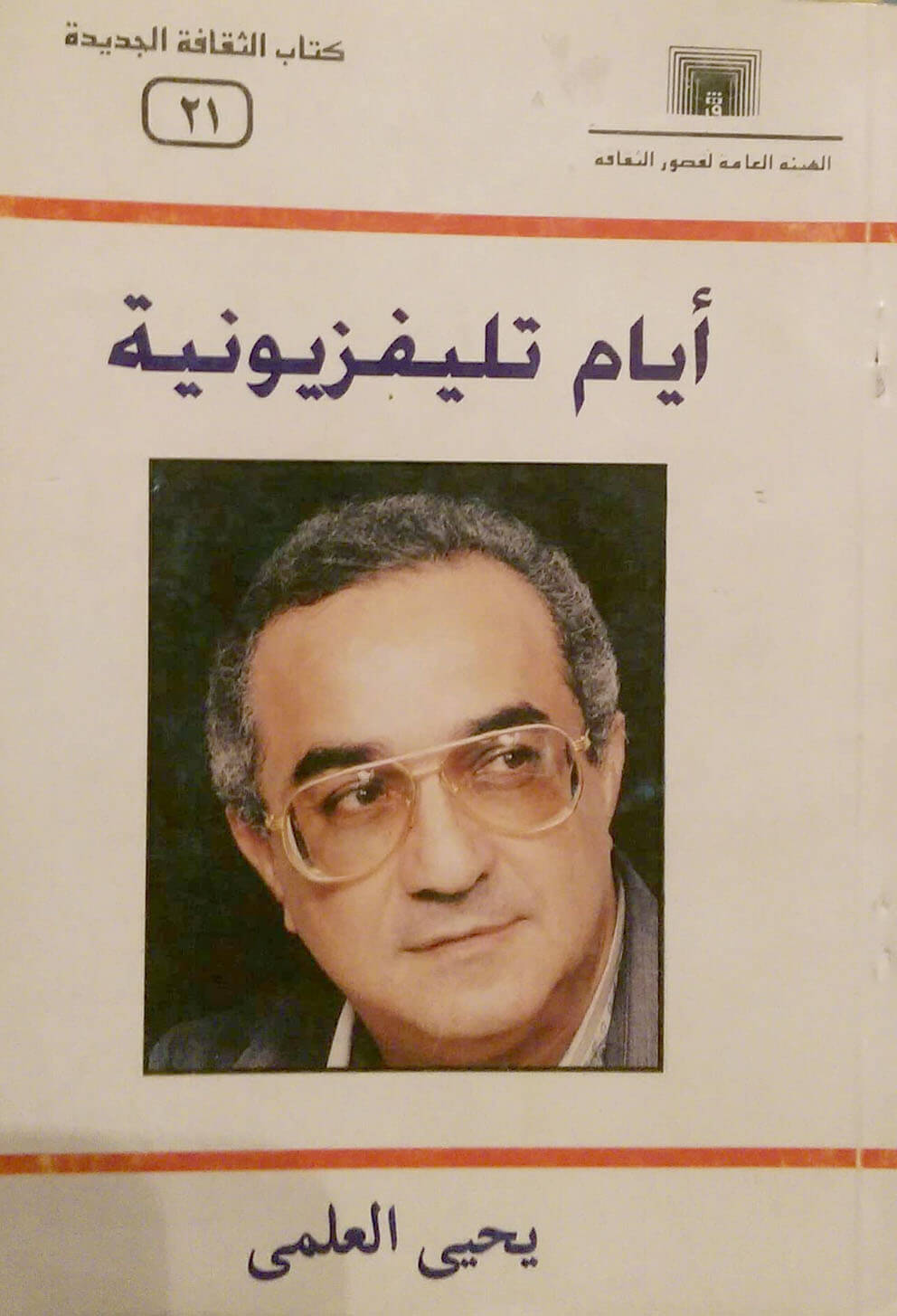 كتب : أحمد السماحي
كتب : أحمد السماحي
ما زالنا مع كتاب (أيام تليفزيونية) تأليف المخرج المبدع الكبير (يحيي العلمي) والذي يقول في بداية الكتاب: كانت لي تجارب وكانت لي محاولات مع الكتابة، وكثيرا ما حملت تجاربي ومحاولاتي مع الكلمة أسعى بها إلى كثيرين أقدرهم من أرباب الكلمة وحملة الأقلام، وكنت أجد منهم التشجيع يسبقه النصح بالتأني، وقد قدرت فيما أتى بعد ذلك من أيام هذا النصح حين أدركت كيف أن الكلمة كالكائن الحي لابد لها أن تمر بأطوار النمو والنضج المختلفة لكي تتضح معالمها وتصبح لها ملامحها الخاصة ولن يتحقق ذلك إلا بنضج أيام العمر ذاتها.
كنت كثيرا ما أشعر بشعور ذلك العازف الماهر الذي مهما اجتهد وجوده فهو في النهاية محكوم بجملة موسيقية محددة مدونة نوتة موسيقية أبدعها غيره، ودوره فقط أن يعبر عنها بمعاناة إحساسه المرهف.
وينهي (العلمي) مقدمته بقوله لم ابتعد بقلمي عن الأوراق ولم أكف عن محاورات النفس أدونها فوق الأوراق من حين لآخر، حتى صادفتني قلوب كريمة لأصدقاء أدين لهم بالفضل حين أتاحوا لي فرصة نشر بعض ما أكتب فوق صفحات مجلات وصحف مرموقة يشرفون على تحريرها وإدارتها حين اطلعوا على بعض ما كتبت وقدروا كرما منهم أنه يستحق أن ينشر سطورا مطبوعة بعد أن كان حبيس النفس أو حبيس الأدراج.

دموع وانهيارصلاح السعدني
يتحدث (العلمي) فى كتابه (أيام تليفزيونية) عن بداية معرفته بالكاتب والأديب الكبير (جمال الغيطاني) أثناء إخراجه لبرنامج (كاتب وقصة) فى نهاية الستينات، عندما تم استضافة (الغيطاني) لمناقشته في كتابه الأول (أوراق شاب عاش منذ ألف عام).
ويقول (العلمي): في نهاية الستينات كنت مبهورا بظهور الموجات الجديدة في السينما العالمية، حيث التلقائية في التعبير عن الأحداث والمشاعر، وحيث التداخل بين الزمن والخاطر والحدث، والمزج بين الواقع والحلم، والتنقيب وبعمق للبحث عن لحظة (التلبس الإنساني) فكرة أو شعورا، وحينما قرأت قصة (أيام الرعب) أحسست أنني أضع يدي على تجربة مصرية تواكب هذه الموجات الجديدة دون أن تقلدها أو حتى تتأثر بها.
ولا زلت أذكر بعض المشاهد من قصة (أيام الرعب) بعد أن حولتها فى نهاية الستينات إلى تمثيلية تليفزيونية يقف في نهايتها البطل وكأن يجسده الفنان الشاب يومها (صلاح السعدني) يقف وسط ميدان الحسين وهو يحمل بطاقته في يده يصرخ وسط ضجة المولد برقمها دون أن يذكر اسمه، ينبه تلك الجماهير التى استغرقتها ضجة المولد وأحداثه بأن (عويضة) لا يزال يتربص ببندقيته والخوف كل الخوف أن يطلق الرصاص في ظهورهم غدرا وغيلة، كان ذلك في أعقاب نكسة عام 1967 ولم نكن قد أخذنا بثأرنا القومي.
ولا زلت أيضا أذكر ذلك المشهد قبل الأخير من التمثيلية حينما أحس بطل القصة كأنه محاط بالآلف من الوجوه كلها تحمل الملامح البشعة لـ (عويضة) الذي يرمز ليد البطش والغدر وآلاف من فوهات البنادق تحاصره كأنها قضبان زنزانة من الجحيم، فلم يجد له من ملاذ يهرب إليه سوى ضريح الحسين سيد شباب شهداء الجنة يذرف أمامه الدموع يطلب منه أن يتشفع له وأن يحميه من (عويضة) وكأنما يستدعي لذاكرته وذاكرتنا ما حدث له حين تكاثرت عليه حراب الغدر وسيوف الضلالة.
لازلت أذكر دموع (صلاح السعدني) التى انفجرت من عينيه وارتجافة جسده الشديدة وكأنما أصابته الحمى، ثم ذلك الانهيار الذي وصل إلى حد الإغماء فور انتهائه من المشهد وسط دموع التأثر فى عيون جميع الحاضرين بالاستديو، كانت الهموم واحدة والأحزان مشتركة ولم يكن (صلاح) يؤدي كلمات حوار بل كانت الكلمات تخرج منه كما كتبها (جمال الغيطاني) ممزوجة بأشجان اللحظة في نفوسنا جميعا في ذلك الزمان، وحتى نخرج (صلاح السعدني) من حالة الاكتئاب والانهيار التى مر بها اصطحبته أنا و(جمال الغيطاني) وخرجنا نبحث عن نسمات ترطب النفس فى ليل القاهرة المظلم وأحزان يونيو لم يمر عليها أكثر من أسابيع والأضواء زرقاء كابية، ومياه النيل ساخنة حارقة كأنها بالفعل دموع إيزيس الباحثة عن أشلاء حبيبها أوزوريس.

هو ونجيب محفوظ
تحت عنوان (الدنيا مالها يا زعبلاوي) يتحدث (العلمي) عن علاقته وعشقه لأديب جائزة نوبل العالمية (نجيب محفوظ) فيقول: كنت يا صاحب نوبل بالنسبة لي هتافا اسمعه من حناجر مظاهرة مصرية تجوب أحياء القاهرة القديمة تهتف بحرية مصر واستقلالها، كنت مشعلا يضيئ ليلها الطويل، وكنت كاتم الأسرار لما يدور خلف نوافذ البيوت المغلقة أمام برودة الشتاء في أنحاء الجمالية وبين القصرين.
ويضيف (العلمي): اقتربت من (نجيب مفوظ) حينما أقدمت على إخراج قصته القصيرة (زعبلاوي) ضمن حلقات مسلسل (كاتب وقصة) في نهاية الستينات، ولعل هذه القصة كانت أحد العلامات الأولى لفلسفاته القصصية التى اتبع فيها أسلوب الرمز والتى كتبت عنها أقلام كثير من النقاد والدارسين.
ولكن هذه القصة بالذات كانت بالنسبة لي كشفا لكثير من التأملات والأفكار الى جانب أنها كانت دعوة لاستجلاء كثير مما تختلج به النفس من الخواطر الحائرة في رحلة البحث عن حقائق الحياة وخاصة في مرحلة الشباب حين كنت أشعر بفورة العقل والوجدان حيث تخرج من أحشاء النفس عشرات من الأسئلة لا ندري لمن نوجهها وكأنما المصير المحتوم أن يظل البحث عن الإجابة هو حكم مقدر علينا، وإذا بـ (نجيب محفوظ) كالبوصلة الهادية إلى طريق البحث وكالضوء الكاشف لعلامات الطريق، يهبنا تجربته ويعطينا فكره وإبداعه، وشجاعة الرأي واقعا أو رمزا يدلنا إلى منهاج البحث.
ويبقى البطل في قصة (زعبلاوي) يحمل على كتفه حيرة الإنسان في مواجهة غوامض الحياة الإنسانية، يصوره (نجيب محفوظ) إنسانا لم يحدد له عمرا يعاني من مرض لم يحدد له أعراضا يبحث عن دواء لم يصف لنا تركيبته السحرية، لكن الدواء عند رجل أسماه (الزعبلاوي)، ولكي تعرف مصدر هذا الاسم يذكر لنا الكاتب مطلع تلك الأغنية الفلكلورية القديمة: (الدنيا مالها يا زعبلاوي، شجلبوا حالها ومين يداوي).
وأثناء وبعد إخراجي لهذه القصة كان لدى (العلمي) العديد من الأسئلة التى تخص القصة الجريئة ولكنه عندما قابل صاحب نوبل أخفى أسئلته داخل نفسه ولسان حاله يقول: سوف يسألك هو: الست أنت الآخر تبحث عن زعبلاوي؟!
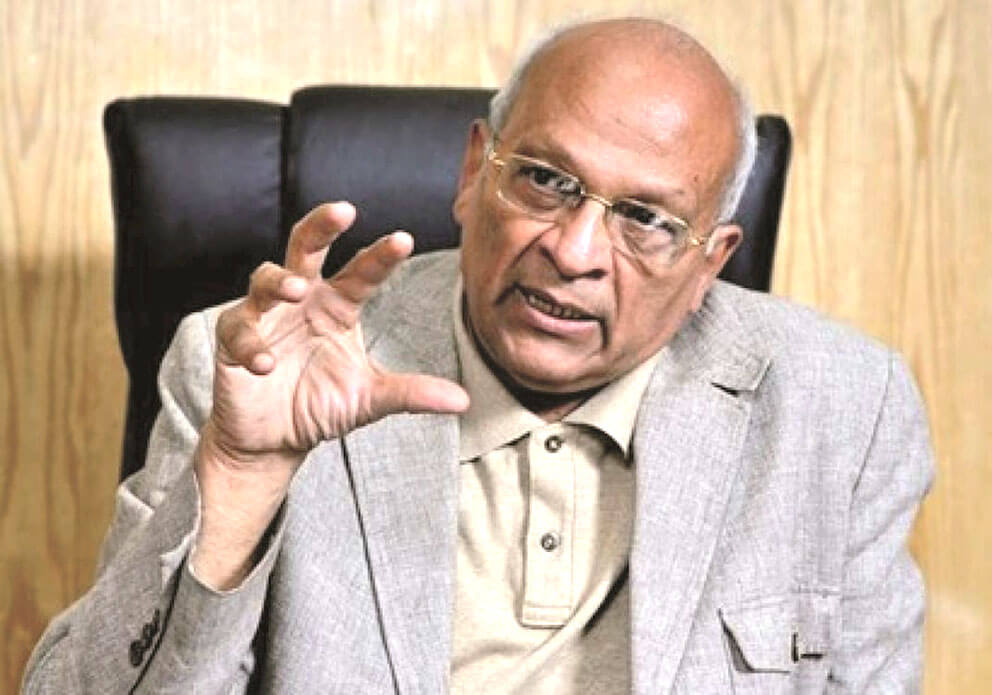
أجمل وأحزن قصة حب
من الحكايات الهامة التى أحب أن أتوقف عندها فى كتاب (أيام تليفزيونية) هذه الحكاية المليئة بالرومانسية، والغارقة في الشجن، والمطرزة بالألم، والتى حملت إسم (وقائع محاكمة الدكتور محمد) والتى يقول فيها : كانت المهمة شاقة وعسيرة على نفسي لكني لم أجد عذرا للفرار من القيام بها، وأعترف أنني تلقيت ذلك المظروف الأصفر الكبير الممتلئ بالأوراق وعليه أختام البريد بالعربية والإنجليزية، لم أكن أتصور بمجرد أن فتحته وقرأت الرسالة الموجزة والتى تخصني بداخله أنني سوف أصبح طرفا فى قصة تفوق إبداع ما يمكن أن يبدعه خيال روائي كبير.
واعترف أيضا أنني بمجرد أن انتهيت من قراءة السطور القليلة للرسالة شعرت كأن بركانا من الغضب والثورة عاد ينفجر من جديد بعد هدوء استمر لأكثر من عام مضى.
الرسالة والمظروف كما تدل أختام البريد قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية حيث هاجر صديقي الدكتور (محمد) كانت سطور الرسالة تقول: (صديقي .. أرجوك أرجئ محاكمتك لأيام قادمة فربما يجمعنا لقاء أروي لك فيه ما لا تعرفه من الأحداث والوقائع، وبعدها سوف أرضي بحكمك حتى ولو كان بالإدانة، الآن فقط أرجوك أن تحمل هذه الرسائل والصور وتسلمها لها – إن وجدتها – وإن لم تجدها فلن يبقى لي سوى رجاء أخير ان تقوم بنفسك بحرق هذه الرسائل والصور وأغفر لي أنني لم أرسل لك عنواني هنا فأنا لا أريد أن أعرف منك أو من أي انسان ما أخاف أن أعرفه، وإن كنت أتوقعه، وعسى أن يغفر لي الله .. أخوك محمد).
وعلى طريقة الفلاش باك وأثناء ذهابه إلى المكان الذي حدده له صديقه وهو ضاحية المعادي يسترجع مخرجنا الكبير (يحيي العلمي) كيف تعرف على صديقه (محمد) الطبيب الفنان الحساس الرومانسي الذي كان عازفا بارعا لآلة البيانو، والذي حضر يوما إلى صديقه (يحيي العلمي) فى الاستديو فصادف (سها) ابنة الدكتور (حسين) التى رأها مع والداها فى الاستديو فى برنامج من إخراج (العلمي) فوقع في حبها وعاشا معا أجمل قصة حب يمكن أن يتخيلها بشر، وتمت خطبتهما.

حتى كان ذلك اليوم الذي لا منطق له قبل أسبوع واحد من عقد القران حينما وصله صوت صديقه (محمد) عبر سماعة التليفون مغلفا بجلبة المكان الذي يحدثه منه، صاح فيه وكأنما يدعوه لكي يرفع صوته من أجل أن يعي كلماته التى وصلته متقطعة متعثرة، فقال له: ماذا تقول؟! فقال له: أحدثك من مطار القاهرة، ماذا تعني؟ أغادر مصر الآن بعد دقائق، إلى أين ولماذا؟ إلى حيث لا عودة، قد فسخت خطبتي من سها!، صرخ فيه بكل الدهشة والغضب والثورة: لماذا؟ قال والدموع يشعر بها تبلل كلماته عبر سماعة التليفون: لأنني أحبها!، وأغلق سماعة التليفون واختفى محمد، وكما اختفى (محمد) لم يستطع (العلمي) أيضا أن يواجه الدكتور (حسين) أو يواجه (سها) فآثرهو الآخر أن يختفي!.
ويواصل (العلمي) تكملة القصة التى تنتهي بمفاجأة لا يتوقعها أحد! والسؤال أين هذه القصة الرومانسية الرائعة المليئة بالمفاجآت من الدراما؟!.


