بقلم المخرج المسرحي الكبير : عصام السيد
في نهاية سبعينات القرن الماضى قرر أستاذي حسن عبد السلام تقديم أوبريت (ليلة من ألف ليلة) للعبقرى بيرم التونسى و من ألحان الملحن الكبير أحمد صدقى في المسرح الغنائى ( هكذا كان اسمه قبل أن يتغير الى الفرقة الغنائية و الاستعراضية )، و كانت بطولة العمل للفنان الكبير كارم محمود ، و بعد الافتتاح بفترة حالت ظروف الفنان الكبير من استكمال العرض ، فقرر أستاذى إسناد البطولة للصوت الجديد (على الحجار) و ترك لى مهمة تدريبه على المشاهد التمثيلية ، و منذ تلك اللحظة نشأت بيننا صداقة قوية ، و عن طريق ( الحجار ) تعرفت على الصحفى و الكاتب ( سامى فريد ) الذى كان يعمل بجريدة الأهرام في قسم السكرتارية الفنية و الذى كان معجباً بصوت الحجار و مؤمنا بموهبته أشد الايمان ، و من أشد المناصرين له حتى قبل أن يحقق نجوميته الكبيرة ، حتى أنه سعى إلى التعرف على الحجار بمجرد أن سمعه في برنامج تليفزيونى يغنى مع فرقة التخت العربى ، فصرنا نحن الثلاثة أصدقاء لا نكاد نفترق لسنوات .

و الأسبوع الماضى فاجأني خبر رحيل الصديق العزيز ( سامى فريد ) ، و برغم إيماني العميق بأن لله ما أعطى و لله ما أخذ ، و إنا لله و إنا إليه راجعون ، و أن صديقى في مكان أفضل ، إلا أن فراق الأصدقاء مهما باعدت بينهم الأيام من أصعب الأشياء على النفس ، خاصة من هم على شاكلة هذا الرجل ( السامى ) طيب القلب ، الذى امتاز طوال مسيرته بسمو أخلاقى نادر ، و كان محبا للموهوبين ، مشجعا لهم في مجالات عدة ، مابين الموسيقى و الغناء و التمثيل و الأدب و الصحافة .
كان الرجل يملك شخصية آسرة، بابتسامته الودودة و صوته الخفيض ، بمجرد أن تعرفه تحس أنكما تلاقيتما من قبل ، و أن بينكما تاريخ طويل ، يساعد على هذا طريقته الطيبة و روحه المرحة و تفاؤله الكبير و لقائه المرحب و المتهلل كلما رأى أحد أصدقائه . كثيرا ما كنت أزوره بجريدة الاهرام ، بعد أن توثقت بيننا الصداقة ، و لم تكن زياراتي بموعد ، ففي أي ساعة من ساعات النهار أدخل الى الأهرام لأجده هناك و كأنه لا يغادره ، حيث كان عمله يقتضى قضاء وقت طويل يقرب من الساعات العشر أو قد تزيد ، فقد يدخل الى مبنى الجريدة صباحا و يخرج منها صباح اليوم التالي بعد صدور الطبعات المتعددة من الجريدة .
و كم جمعتنا جلسات في كافيتريا الدور الرابع الملاصقة لصالة التحرير كما جمعتنا لقاءات فنيه و عائلية عديدة حتى صرنا و كأننا عائلة واحدة تضم الأستاذ سامى و الفنان الكبير على الحجار و الموسيقار الكبير منير الوسيمى و الفنان القدير سامح الصريطى ، فالأستاذ سامى كان يملك من الطيبة و التفهم و الحنو ما جعلنا نلجأ له في المشاكل و الملمات ، فكانت خبرته في الحياة عونا لنا ، و ساعدتنا ابتسامته الهادئة على تقبل المصاعب ، بل أن حياته نفسها كانت مثالا للكفاح الهادئ الصامت البعيد عن الشكوى و الضجيج ، و لطيبة قلبه الشديدة قيد الله له من يأخذ بيده دون أن يطلب أو حتى دون أن يسعى .

ففي البداية كان الأستاذ سامى يعمل بمجلة ( المجلة ) التي رأس تحريرها الكاتب الكبير يحيي حقى ، يكتب القصة و المقال و يترجم و يعرض الكتب ، و لكن بعد النكسة أغلقت ( المجلة ) أبوابها تحت إلحاح ضغط المصروفات و صار بلا عمل ، و لكن الصدفة دفعت به في عام 1970 الى دخول أكبر صرح صحفى في ذلك الحين ( جريدة الأهرام ) التي كانت تضم أكبر كتاب و مفكري مصر و أعظم صحافييها ، و لكن في منصب سكرتير التحرير و هو المسئول عن ترتيب مواد الصحيفة و يشارك في إخراجها و اختيار العناوين و مراجعة المادة المكتوبة ، و هى مسئولية ضخمة في جريدة كالأهرام تصدر في 24 صفحة على الأقل يوميا و أحيانا ستة و ثلاثين غير الملاحق .
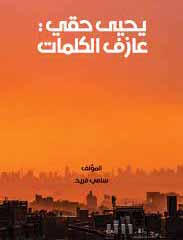
و تحت ضغط العمل و حجم المسئولية غرق في بحار الأهرام و وجد نفسه ( على حد قوله ) قد سقط فيما يشبه الكمين الذى لا فرار منه فابتعد عن هوايته و حبه للأدب. و لكن للمرة الثانية تقوده الصدفة الى لقاء الكاتب الكبير أحمد بهجت – الذى كان يتابع إنتاجه الأدبي منذ كان يكتب في مجلة المجلة – ليطلب منه قصة قصيرة لمجلة الإذاعة و التليفزيون التي تولى ( بهجت ) رئاسة تحريرها ، و بمجرد نشر القصة الأولى طالبه بالثانية ، و هكذا انفتحت له أبواب الأمل مرة أخرى ، ليعود الى حبه الأول : القصة القصيرة التي يكتبها باحترافية عالية ، حيث يبدأ من نقطة انفجار الحدث أو تعقد الحدث ثم يتحرك الزمن إما إلى الأمام فيعرف القارئ مصير الشخصيات ، أو إلى الخلف فيعلم القارئ أسباب ما حدث ، و في كلا الحالين فإنه

يثير شهية القارئ إلى إكمال القراءة و معرفة ما يرمى إليه الكاتب ، كما استخدم نفس التقنية – و لكن بتعقيد أكبر – في رواية طويلة هى ( أبو الدهب ) حيث يبدأ من اللحظة التي يفكر فيها المملوك محمد بك أبو الدهب في خيانة أستاذه و معلمه على بك الكبير ، و يأتي التعقيد أن الراوى في الرواية هو بطلها أبو الدهب ، و من خلال ما يشبه المنولوج الطويل في داخل عقل البطل نعرف الأحداث ، بل و نهاية البطل الذى يصاب بحالة من الجنون لا يصفها لنا الكاتب و لكن نستشعرها من خلال حديث الراوى لنفسه .
و هكذا كان العمل الصحفى اليومى معطلا لموهبة أدبية من الطراز الرفيع ، و لكن لأن صديقى من ( الأرواح الطيبة ) كانت الفرص تأتى اليه و كأنها صدفة دبرها

القدر، و لم تنقطع الصدف عن حياته تدفعه كلما توقف و تسنده كلما تعثر ، فلقد اضطر ذات يوم أن يكتب (اعترافات زوج) بديلا للأستاذ احمد بهجت بسبب سفره إلى الحج ، ثم اضطر مرة أخرى إلى كتابة (اعترافات زوجة) ، و لكن تلك الصدف أيقظت الحس الساخر فيه ، فقدم لنا واحدا من أجمل كتبه في الأدب الساخر يحمل عنوان ( الرجال لا يعرفون الآه ) ثم تبعه بكتابه ( مذكرات زوج سعيد جدا ) ضمن كتبه الكثيرة المتنوعة التي تزيد على 60 كتاب ما بين القصة القصيرة و الرواية و المسرحية و المقالة ، و منها كتابه الرائع ( صالة التحرير ) الذى يروى فيه قصته مع الصحافة و الأدب .
و لكن المقالات التي يضمها الكتاب لا تروى في الحقيقة رحلته و حده ، بل تروى جزءا هاما من تاريخ الوطن ، حيث كانت التغيرات التي طرأت على جريدة (الأهرام) خلال سنوات عمله بها انعكاس لما يحدث في مصر، إلى جانب أن المقالات تكشف كواليس الصحافة المصرية و تمتلئ بالدروس في العمل الصحفى و لكن الأهم في الكتاب – من وجهة نظرى – هو أنه يفيض بالحب و التقدير لزملاء المهنة من الصحفيين و الكتاب ، يعترف فيه بفضل من كان له فضل في وفاء رائع ، و يمتدح فيه من كان موهوبا و لم ينل حظا في إنصاف و تقدير ، و يسمو في تلك الصفحات عن ذكر ما يجرح أو تصفية الحسابات أو الانتقام ممن أساءوا إليه . و يأتي في الكتاب ذكر لأستاذه و أستاذ الأجيال ( يحيي حقى ) الذى كان يعتبر سامى ابنا له ، على الرغم من أنه كتب عن أستاذه عدة كتب و مجموعة من المقالات و الدراسات و لكنه كان وفيا لذكراه ذاكرا باستمرار لأفضاله ، معترفا دوما بأستاذيته في وفاء نادر .
وداعا صديقى ، أو لنقل إلى لقاء فالوداع لا يليق بك ، فقد كنت حقا ( ساميا فريدا ).


