بقلم المخرج المسرحي الكبير : عصام السيد
فوجئت – كما كثيرين غيرى – بالدعوة التى أطلقها السيد الرئيس لإقامة حوار وطنى ، فقد كنت أظن أنه اكتفى بالحوارات التى تتم من خلال مؤتمرات الشباب ، و لكن هذه الدعوة – بناء على ما أوضحه فى خطابه – جاءت بناء على تغيرات سياسية واقتصادية تجتاح العالم كله و تحتاج منا للتكاتف المبنى على التفاهم و الاتفاق لتجاوز تلك المرحلة .
و فى اعتقادى أن من رحبوا بتلك الدعوة يدركون أننا جميعا فى مركب واحد ، وعلينا ان نبقيها عائمة وسط العواصف و الأنواء ، و هذا يستلزم اتفاقا عاما شاملا بين كل الأطراف الفاعلة ، التى لم تتلوث يدها بدم أو بمعنى آخر عودة التحالف الذى قام بثورة 30 يونيو ليلعب دورا أساسيا فى المرحلة القادمة ، دون إقصاء لأى من اطرافه.
و لقد بادر السيد الرئيس – بذكاء شديد يحسد عليه – بترميم بعض الشروخ التى أصابت ذلك التحالف بتقديم تحية خاصة للسيد ( حمدين صباحى ) يوم إفطار العائلة المصرية، و مصافحته فى ود شديد ، و هى شروخ صنعها صبية صغار اتخذوا من مهاجمة (صباحى) وسيلة للتقرب للنظام لا يحتاجها و أظنه لا يرغبها ، و الدليل احتفاء السيد الرئيس به .

و لعل اللحظة كانت أصعب على هؤلاء الصبية الذين اتهموا السيد ( خالد داوود ) بالخيانة و العمالة و هم يشاهدون مصافحة السيد الرئيس له . و لعل الرسالة التى أرادها السيد الرئيس أن تكون قد وصلت إليهم بالكف عن مهاجمة أجنحة التحالف السابق ، و أن هناك معارضة وطنية تعمل من خلال الوسائل المشروعة يجب احترامها . و اكتملت دعوة الرئيس للحوار بالإفراج عن بعض السجناء و عودة لجنة العفو الرئاسى إلى العمل لفتح صفحة جديدة فى التعامل بين الفرقاء المختلفين ، لأن اختلافهم فى الوسائل و ليس اختلاف على الأهداف . و من هذا الاختلاف يأتى الحوار.
و إذا كان البعض يتصور أن الحوار المنشود هو بعض جلسات يجتمع فيها المتكلمون للنقاش و الخلوص إلى توصيات أو نتائج ، و ينتهى الأمر و يغلق باب الحوار فهذا تصور قاصر ، فإن الحوار الوطنى الحقيقى هو عملية ممتدة ، لا تنتهى بانتهاء جلساته، بل هى عمليات اجتماعية و سياسية و ثقافية دائمة و دائبة ، تتمثل فى أنشطة عدة ، فقد تصلح التوصيات و القرارات فى ترتيب الأولويات اقتصاديا ، لكنها لا تصلح فى تعميق قبول الآخر – مثلا – أو زيادة وعى المواطن ، أو تعميق المشاركة السياسية ، و هى أمور لا يكتمل الحوار إلا بها و لن يحقق نتائجه المنشودة دونها .

و إذا كنا فى أشد الحاجة إلى هذا الحوار بمعناه الواسع و الممتد ، و فى أشد الحاجة إلى نجاحه ، فالحوار نفسه فى أشد الحاجة إلى إجراءات سريعة تسبقه و توازيه وتستمر كى نضمن فاعليته ، فعلى سبيل المثال – لا الحصر – ليس من المعقول أو المقبول أن يبدأ الحوار فى ظل رقابة جائرة ، سواء من أجهزة الرقابة المختلفة او من الرقابة المجتمعية و الدينية ، أو ممن نصبوا أنفسهم أوصياء على أفعال و أقوال الشعب المصرى و متحدثين باسمه ، فلقد أصبحت قوى الرقابة المختلفة و المتعدد خانقة وقادرة على إسكات أى صوت مختلف ، فحرية التعبير ضرورة لاستمرار أى حوار و إلا تحول الى حديث من طرف واحد .
و إذا بدأنا بتحديد جهات الرقابة الرسمية فسنجد انها تنقسم الى قسمين : الأولى هى جهات رقابة بحكم القانون ، و الثانية جهات تغولت على وظيفة الجهات الرقابية وادعت لنفسها مهام رقابية و أولها المجلس الأعلى للاعلام الذى من المفترض – بحكم القانون – مساندته لحرية الابداع . و لم يكتف هذا المجلس بتعنت أجهزة الرقابة بل زادها بما فرض من قواعد رقابية ليست من اختصاصه ، و علينا أن نتخيل جلسات الحوار تدور و هذا المجلس يصدر تعليماته بما يجب أن يقال و بما لا يجب أن يقال!!، إن من واجب المجلس أن يوجه الإعلام و لكن توجيهات تخص إتاحة الفرصة لكل الآراء ، و أن يقوم بمهمته الأساسية فى منع الاغتيال المعنوى للمخالفين لرأى الحكومة مادام صاحب الرأى لا يسب و لا يتهجم و لا ينتمى لجماعة ضالة مضللة .
أما جهة الرقابة الرسمية فحالها للأسف محزن ، فلقد وصل الأمر بها أن أصبح المنع هو الأساس و التصريح هو الاستثناء ، فلو نجى العمل من التأخيرات المتتالية التى تصل لشهور فلن ينجو من قواعد غير مكتوبة تمنع ظهور شخصيات معينة أو توجيه انتقادات لأى من الجهات الحكومية ، بل وصل الأمر لمنع ظهور الضباط من الأساس فى أى عمل فنى – إلا فى إنتاجات الشئون المعنوية أو الشركة المتحدة – و لن تجد قرارا بالمنع تناقشه أو تعارضه ، بل تكتم تام و لن تحصل على ترخيص بالعرض او حتى قرارا بالرفض . و ليس هذا فى الأعمال الجديدة فقط ، بل اصبحت الرقابة (بأثر رجعى) فلقد تم منع نصوص تم تقديمها سابقا و حصلت على موافقات رقابية فى عصور كتابتها ، و الآن يتم منع إعادة تقديمها ، لأنها خضعت لتفسيرات رقيب يخشى على مقعده فيغلق الأبواب و الشبابيك ليس فى وجه الريح بل فى وجه أى نسمة و لو عابرة .
و هكذا أصبحت الرقابة ( على الكيف ) و لا تخضع سوى للتفسير الشخصى للرقيب و بما يحفظ له مقعده و بقاؤه عليه . و يتم ضرب عرض الحائط بالقانون المنظم لعمل الرقابة الذى ينص على أن ( إذا لم ترد الرقابة على طلب الترخيص خلال شهر من التقدم بالطلب يصبح العمل الفنى حائزا على الترخيص )، أما فى حالة الرفض فيكون الرفض خلال المدة القانونية و مسببا ، و من حق المبدع – قانونا – التقدم إلى لجنة محايدة تبحث التظلمات و تبت فى نزاعات المبدعين مع الرقابة . و لكن هذه اللجنة لم تعد مفعلة و ماتت إكلينيكيا .
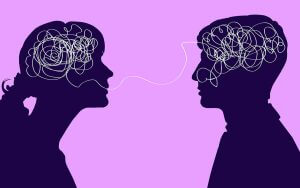
أما إذا نجى العمل من الرقابة فهناك كتيبة من هواة الشهرة نصبوا أنفسهم حماة للشرف و الفضيلة و المجتمع يمارسون حق رفع القضايا على أى عمل فنى لإيقافه و سجن مبدعيه . و برغم أن عماد الحوار هو تقبل الرأى الآخر ، و مناقشته و ليس قمعه و اقصائه و سجن قائليه ، و الإبداع الفنى هو صورة للمجتمع و أفراده ، يناقش مشاكلهم و احتياجاتهم و آمالهم و آلامهم ، و لن يكون هناك حوار جاد و هناك متربصون بالإبداع ، و لذا فإن إيقاف قضايا الحسبة ( أى القضايا التى يرفعها أشخاص بحجة حماية المجتمع ) شرط أساسى فى إنجاح الحوار .
إن جمهورية جديدة فى سبيلها إلى القيام ، و لن تقوم إلا على دعائم الديمقراطية ، فكيف ستقوم و نحن نفتقد – كأفراد – لأبسط قواعدها و نسعى إلى قمع و تكميم الآراء المخالفة لنا ، و نرى فى فيلم أنه ( تشويه لمصر ) و نرى فى مسلسل اجتماعى ازدراء بالدين لأنه ناقش قوانين و فقه من وضع بشر ، و نقيم من أنفسنا رقباء ، و نطالب الدولة بالمنع و الحذف ثم ندعى أننا نسعى الى الديمقراطية .
فليكن من الحوار الوطنى وسيلة لأن نتعلم فن الخلاف و قواعد الاختلاف و ننبذ القمع و المنع و المصادرة.
و للحديث بقية ..


